
مناسبة كتابة هذه المقالة: اللقاء الإذاعي الذي أجراه معي الصديق الأستاذ عبد الحليم حمود في الإذاعة اللبنانية في شهر آب 2025، حول تسعيرة الأعمال الفنية.
عَرَفَتْ لعبة السوق الفنّي قفزات هائلة في أوقاتنا الحالية، ووصلت أسعار بعض الأعمال الفنية لفنانين معاصرين إلى حدود غير مسبوقة، بل إلى عشرات ملايين الدولارات.
فما أسباب هذا الارتفاع؟
ومَن هم الفنانون أصحاب الحظوة في عملية البيع؟
وما دور السوق وجامعي الأعمال والنقّاد وغيرهم في هذه اللعبة؟
أسئلة نحاول المرور عليها في هذه المقالة، عساها تُضيء بعض جوانب هذه العملية التي تشبه لعبة البورصة العالمية.
اختلفت عملية السوق في عصرنا عن سابقاتها؛ ففي القرن السابع عشر، كان للفنانين موقع خاص؛ إذ كانوا حرفيّين في خدمة الملك. وعندما يُقام معرض مشترك، كانت أعمال فنّاني البلاط تُعلَّق في الأعلى لتمييزها عن غيرها.
أدت المتاحف فيما بعد دور المشرف والسوق، وقامت بدور العرض والطلب قبل ولادة الغاليريهات وما شابهها.
اعتمد فن التصوير سابقًا على رعاية الفن (Le mécénat). وما تغيّر بالنسبة إلى الفنانين هو عدد جامعي الأعمال، الذي تزايد في هذه الآونة.
الفنان الأميركي ما بعد الطليعي (Post-Avant-garde) جوليان شنايبل (Julian Schnabel) – الذي يُنسب إلى تيار “نسيج-تزيين” (Pattern-décoration) – كان في الثلاثينيات من عمره عندما بيعت أعماله بأسعار خيالية تصل إلى ملايين الدولارات، واستمر ارتفاع أسعارها حتى بعد مرور أكثر من نصف قرن.
عام 1913، بيعت لوحة لبيكاسو (Picasso) – وكان عمره حينها 32 عامًا – بـ 13 ألف فرنك من الذهب، أي أكثر من عشرة أضعاف راتب عامل لمدة عام كامل، كما صرّح أحدهم. وإذا بحثنا في أسباب هذا السعر المرتفع نسبةً لعمره، نجدها في استراتيجية السوق. وهذا الأمر ينطبق على نجوم فن التصوير (La peinture) الحاليين في الخارج، ولا سيما في أمريكا وألمانيا.
من ناحية أخرى، للحروب تأثير سلبي على تجارة الأعمال الفنية؛ ففي أثناء الحربين العالميتين تهاوت الأسعار كثيرًا. عام 1927، كان بالإمكان شراء عمل كبير للفنان الفرنسي فرنان ليجيه (Fernand Léger) بأربعة آلاف أو خمسة آلاف فرنك فرنسي، بينما بلغ سعر هذا العمل في الثمانينيات من القرن الفائت مليوني دولار أمريكي!
هناك ظواهر جديدة دخلت السوق الفنّي منذ تلك الفترة. فأصبح سوق العمل عالميًّا، كما رفعت متاحف الفن المعاصر الأسعار بسبب تنافسها على شراء أعمال الفنانين. وربط البعض أسباب هذه الحمّى في السوق بوصول طبقات جديدة من المجتمع إلى الثراء والسلطة. إنها لعبة بورصة أيضًا، حسب قول أحد الأوروبيين: “عندما نمتلك السيارات والفيلات، نبدأ بشراء الفن”. إذًا، موجة اقتصادية حملت إلى شواطئ الفن هواةً جددًا، وطبقة جديدة من المشترين، يقابلها سوق ثانٍ هو الغاليري.
عام 1950، كان سعر لوحة مون دريان ثمانيمئة فرنك فرنسي، بينما وصل هذا السعر في الثمانينيات إلى خمسة ملايين دولار للعمل الواحد (وكان الدولار حينها يُعادل ستة فرنكات فرنسية).
أما الفنان الأميركي تسي تويمبلي (Cy Twombly)، فقد بيعت لوحته مؤخرًا بسبعين مليون دولار! وهي عبارة عن خطوط دائرية تشبه شبكة من الشريط الشائك، مرسومة بعفوية تُشبه رسوم الأطفال
تتغيّر أسعار أعمال الفنانين، بينما تبقى أسعار البعض منها كما هي من دون تغيير عبر السنوات!
ثمّة أعمالٌ فنيّة على درجة كبيرة من الأهميّة، لا لِقيمتها التشكيليّة فحسب، بل لأنّها تنتمي إلى لحظةٍ معيّنة من التاريخ. لقد أدرك السوقُ بسرعةٍ دورَ التاريخ (حيث تؤدي المتاحف هذا الدور): هذا العمل أو الشيء تاريخيّ، إذًا هو ثمين. فالأعمال الجاهزة الصنع (Ready-made) تبدو شيئًا تافهًا لا يُقدَّر كعملٍ فنّيٍ بحدّ ذاته، بل لملاءمته التاريخيّة. وعملٌ للفنّان الأمريكي “جيف كونز”(Jeff Koons) — في غاية السخافة والقباحة، عبارةٌ عن حيواناتٍ مصنوعةٍ من البالونات — لا يُعَدُّ عملًا فنّيًّا حقيقيًّا، لمجرّد أنّ سعره باهظ.
من محرّكات الحياة إبداعُ أشياء جديدة، لكن – وبشكلٍ متناقض – نلاحظ أنّ الجديد لا يُستقبل كما ينبغي! شيءٌ لافتٌ للنظر. نسمع أحيانًا قولًا لأحد الفنانين بأنّ عمله السابق كان أفضل…
منذ تجربة الفنان الفرنسي “مارسيل دوشامب”(Marcel Duchamp)، نلاحظ أنّ الفنان قلّما “يعرقُ” في محترفه، كما كان الحال سابقًا مع الفنانين الذين بذلوا وقتًا طويلًا وجهدًا متواصلًا لإنتاج عملهم الفنّي.
عندما نشتري عملًا فنّيًّا، فإنّنا نقتني شيئًا يمتلك قيمته بذاته، أشبه بمعيارٍ ذهبيّ. لكن عندما نشتري عملًا جاهزًا، أو عملًا من الفنّ المفاهيمي (L’art conceptuel)، فإنّنا نشتري مجرّد بقايا.
كونك فنانًا يعني أن تكون علامةً أو ظاهرةً (Symptôme) تعبّر عن تغييراتٍ اجتماعيّة وتحوّلاتٍ في الفكر. فعملك ينتمي إلى منطقة الفنّ، وأنت لا تمارس سوى الفنّ.
من بين الثلاثيّة المعنيّة بسيرورة لعبة السوق (الفنان، صاحب الغاليري، والمشتري)، يبقى الفنّانُ الوحيدَ الذي لا يُدلي برأيه في آلية التسعير والسوق.
أحيانًا، يؤدي النقدُ دورَه في السوق. فقد صرّح أحد الفنانين الفرنسيّين بأنّه يقيم معارضَ أحيانًا من دون أن يبيع فيها، ويرى في ذلك علامةً جيّدة! أمّا الخطورة برأيه، فتكمن في عدم الحديث عن المعرض أصلًا. في ألمانيا، يشترك الفنان والبائع وجامع الأعمال في عمليّة السوق، بالإضافة إلى النقّاد.
مقتنو الأعمال الفنّيّة ينتظرون رأيَ الآخرين في أعمال الفنان ليبنوا على الشيء مقتضاه، كما تؤدي الشهرة والدعاية في المعارض والكتب عن الفنان دورًا محوريًا في تحفيزهم على الشراء. فلماذا لا يعتمدون على أنفسهم في الاختيار؟ قرأتُ كتابًا فرنسيًّا بعنوان “نجاح بيكاسو وإخفاقه” خلاصته أنّ أهمّيّة بيكاسو وعظمته لا تعود إليه وإلى أعماله شخصيًّا فحسب، بل إلى دور الدولة الفرنسيّة في تسليط الضوء عليه عبر دعايةٍ ضخمة. والهدف من ذلك كان استثمارَه في عمليّة الربح الماديّ كفنانٍ يَعيش وينتج على أرضٍ فرنسيّة. والمفارقة أنّ بيكاسو لم يحصل على الجنسيّة الفرنسيّة طوال حياته التي قضاها في فرنسا (حسب رواية صحيفة “لوموند” الفرنسيّة)، فكان يضطرّ كلّ عامٍ إلى متابعة تجديد إقامته هناك! (كتبتُ مؤخّرًا عن هذا الموضوع مقالةً في إحدى الصحف اللبنانيّة).
إذا كان الفنّانُ جيّدًا، فإنّ عمله سيُقدَّر مع الوقت. يمكننا أن نسقطَ فنّانًا وسطيًّا، ولكن لا يمكننا أن نفرضَ مع الزمن فنّانًا سيّئًا. إذًا، قوّة السوق تبقى نسبيّةً إلى حدٍّ كبير. فالسوقُ الفنّي يشبه عمليّة البورصة.
أسعارُ أعمال الطليعيّين، أو الفنّان الحي، لا تعني شيئًا كبيرًا في حدّ ذاتها. إنّها لعبةُ مضاربةٍ فحسب. لا يوجد سوى الزمن الذي يحدّد القيمةَ الفعليّة للعمل: سعرُ لوحة الفنّان الفرنسي هنري ماتيس (Matisse) هو سعرُها الحقيقي. لكنّ سعرَ لوحةٍ لفنّانٍ آخر — كالألمانيّ أنسيلم كيفر (Anselm Kiefer) أو الإيطاليّ ساندرو شيا (Sandro Chia)، على سبيل المثال — من يضمن أن يبقى على حاله بعد خمسين سنةً أو أكثر؟ سؤالٌ كهذا طُرح في ثمانينيّات القرن الماضي.
شراءُ الأعمال الفنّيّة لفنانٍ معيّن ليس معيارًا للنجاح؛ فقد يسقط هذا الفنّان مع الوقت، وقد يحدث العكس. ففان غوغ باع عملًا واحدًا بسعرٍ زهيد، وكذلك الفنّان الروسي فاسيلي كاندينسكي (Wassily Kandinsky)، الذي اشترت منه الدولة الفرنسيّة عملًا واحدًا – عبارة عن جدارية – بسعر يتراوح بين أربعة آلاف وخمسة آلاف فرنك فرنسي فحسب! أمّا الآن، فمن يستطيع الحصول على عملٍ واحدٍ من أعمال هذين الفنّانين؟ على جامعي الأعمال والتجّار والسوق الفنّي والغاليريهات أن يعملوا على تسويق نتاج الفنّانين كي يستمروا في العطاء والإبداع.
نعود إلى فان غوغ لنشير إلى دور أخيه “ثيو” في دعمه، حيث كان يرسل له مبلغًا شهريًا ليشتري به المواد والألوان عالية الجودة. تخيّلوا فان غوغ من دون دعم أخيه، هل كان بمقدوره الاستمرار والوصول إلى ذلك الإبداع الأخّاذ؟ من هنا تبرز أهميّة دعم الفنّانين عبر شراء أعمالهم، لاستمرار عمليّة الخلق والإبداع.
مع مرور الوقت، لا نستطيع – بل يستحيل في رأيي الشخصي – الحكم على أعمال الفنّانين المعاصرين. فلكلٍّ منّا ذوقه الخاص، ولا يوجد من يبلغ الحقيقة المطلقة. ومن المعروف عالميًا أن سعر العمل الفنّي لأي فنّان يزداد بعد كل معرض خاص له بنسبة تتراوح بين عشرة وعشرين بالمئة؛ فلو كان سعر العمل عشرة آلاف دولار أمريكي، يصبح أحد عشر أو اثني عشر ألف دولار بعد المعرض، وهكذا دواليك.
الفنّ جزءٌ منّا. molecule عندما ندفع أثمانًا مرتفعة لأعمال فان غوغ – التي قد تصل إلى المليار دولار – فإنّنا نشتري هويّتنا الخاصة. إنّ قيمة العمل الفنّي وتقديره في السوق الفنّي يختلطان مع ميتولوجيا هذا العمل. يُحكى أن جامع أعمال ياباني أوصى بدفن لوحة لفان غوغ معه، لأنه أحبها وتعلّق بها إلى حدّ الهيام. لكن طلبه رُفض بحجّة أن هذا العمل، وإن امتلكه، هو ملك للبشريّة جمعاء. إن دلّ هذا على شيء، فعلى تعلّق البعض وهيامهم بالأعمال الفنّية إلى حدود لا يمكن تصوّرها…
عبّر أحد النقّاد الأمريكيين في منتصف القرن الماضي عن سوق الفن في أمريكا بقوله: “إن أسعار اللوحات والمنحوتات الأمريكية تتعلّق بشكل طبيعي بمعايير الحياة في البلد. فسعر العمل الفنّي المتوسّط في أمريكا يفوق ضعفين إلى أربعة أضعاف سعر نظيره في أوروبا، باستثناء إنجلترا. ورطة الفنّانين الأمريكيين تكمن في أن الطريقة الوحيدة لعرض أعمالهم خارج أمريكا تكون عبر تجّار الفن، وهؤلاء لا يهتمون بمعارض لا تشبه نظيرتها في أمريكا”.
الأعمال الفنّية، ككلّ نتاجات صناعة الوعي، هي علامات أيديولوجيّة مهمة لها تأثيرها على المناخ الشعبي. في الواقع، السوق الحالي – أكثر من أي وقت مضى – هو الذي يحدّد “أهميّة” نتاجات الفنّان (وبالتأكيد، من دون إنقاص دلالة أدوارها الأيديولوجية). هذا التطوّر مقترحٌ قبل ظهور شبكة عالمية مؤلّفة من غاليريهات متباينة تتعاون بشكل ضيّق، لتشكّل – لأسباب عمليّة – “كارتيل” (اتفاقًا بين الشركات) لإدارة العمليّة بشكل قوي. وقوّةُ البيع ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحالاتٍ معيّنة من جيلٍ جديدٍ من جامعي الأعمال، أولئك الذين يراهنون بجرأةٍ كبيرة.
ثمّة مجموعة أخرى من الأسئلة يمكننا طرحها في محاولة للإجابة عنها لتوضيح بعض الأمور:
من يمسك بالسلطة في حضن السوق؟ البائعون، جامعو الأعمال، مسؤولو المتاحف، أم الفنّانون؟
هل يُمكن القول إنّ هناك فنّانين ضحايا للسوق الفنّي، وآخرين مستفيدين منه؟ وإلى أيّ درجةٍ يُمكن أن يؤثّر السوق الفنّي في عمليّة الخلق الإبداعي؟
هل يُمكن لتطوّر الفنّ حاليًا أن يُعدّل العلاقات التقليدية بين الفنّان والسوق، أو بينه وبين جامع الأعمال؟
ما مستقبل سوق الفنّ المعاصر؟ وهل وصلت أسعار أعمال الفنّانين إلى الحدّ الأقصى، أم ستواصل الارتفاع؟
يتطوّر السوق بفضل زيادة كمّية النقد المدفوع، مضافًا إليها ثقافة الجمهور؛ فجميع الفنّانين يستفيدون من هذا التطوّر. لا نعتقد أنّ السوق قد تشبّع. من ناحية أخرى، يبحث السوق عن تطوير قدرات الفنّان، وعن التقاط أفضل ما عنده. (ولا نقصد هنا السوق اللبناني بالطبع).
يقول أحدهم: “أنا متأكّد من أنّ الفنّان، من خلال قوّة عمله، قادر على توحيد الجمهور الذي يدعمه، نظرًا لقدرة الفنّ على الجمع والتوحيد”.
أمّا الفنّانون الذين اختاروا أن يكونوا مفهوميّين، فقد اختاروا حياةً من دون مكافأة ماليّة. فالفنّان الأمريكي التجريدي الغنائي مارك روتكو (Mark Rothko) لم يتنازل للسوق، وعاش حياةً دراماتيكية. كان يعلم أنّ عمله يمثّل إضافةً حقيقية لهالته الفنّية. ومثالٌ آخر من لبنان هو الفنّان صليبا الدويهي من زغرتا- إهدن، الذي لجأ في أواخر تجربته الفنّية إلى أسلوب التجريد الهندسي الأمريكي (الحافة الصلبة)، ولم يتنازل على الرغم من الانتقادات وظروف الحياة الصعبة. قال لي في أثناء لقائي به في باريس إنّه ما زال يعتاش من بيع أعماله الأولى الواقعية التي تمثّل القرية اللبنانية وما شابهها.
يوجد فنّانون كثر أصبحوا أغنياء، لكنّهم – كما أفاد أحد الباحثين الفرنسيين – “من دون فائدة حقيقية”.
للأسف، هناك جامعو أعمال تغلب عليهم صفة “مستثمر” (Investisseur) أكثر من صفة “جامع أعمال”! فمن لا يُظهر الأعمال التي بحوزته للناس – كما أفاد أحدهم – لا يُعتبر جامعَ أعمالٍ حقيقيًا. بعضهم يخبئ اللوحات في البنوك أو داخل خزائن حديدية متينة خوفًا من سرقتها، بينما يوصي آخرون بدفن لوحة فان غوغ معهم، كما ذكرنا سابقًا!
التقيتُ مؤخّرًا بجامع أعمال لبناني يُعتبر متوسّط الحال، شرح لي حبّه وشغفه بالفن؛ فهو يشتري الأعمال الفنّية بغية الاحتفاظ بها وتعليقها في منزله الذي تحوّل إلى متحفٍ فنّي، حتى إنّه علّق بعض الأعمال على سقف المنزل. هذا الأمر ذكّرني بسقف كنيسة السيستينا في الفاتيكان بروما، التي حوّلها الفنّان الإيطالي مايكل أنجلو (Michelangelo) إلى سماءٍ تسكنها الملائكة والإيمان. فالزمن وحده هو الذي يُمكنه أن يُقوّي الهالة المحيطة بالعمل الفنّي، أو أن ينزعها عنه.
قال أحد الفنّانين الفرنسيين: “عندما أرى أصدقاء فنّانين كانوا قبل سنواتٍ مضطّرين لاستعمال الدراجة الهوائيّة للتنقّل، وأصبحوا اليوم يقتنون شققًا سكنيّة، أقول إنّهم تحوّلوا من منتجين للفنّ إلى منتجين للمال”. والكلّ يعلم أنّ ثمن العمل الفنّي هو جزءٌ من تكوينه.
يختصر الفنان الأمريكي “جوليان شنايبل” قضية السوق الفنّي وبيع الفنان لأعماله بالقول: “لديّ ابنتان وامرأة جميلة وذكيّة. الناس تشتري أعمالي، والصحافة تكتب عنّي. الناس تكتب عن أي شيء، بل تكتب عن الناس التي تشتري أعمالي. أستطيع الذهاب أينما أريد، وآكل ما يحلو لي… وسأواصل الرسم طالما لديّ الأموال”.
يختصر هذا القول الكثير من الأمور، يأتي في مقدمتها أهمية وجود السوق الفنّي وشراء الأعمال الفنّية لتشجيع الفنانين على العطاء المستمر.
وكلمة أخيرة عن لبنان: قد لا تُنتج الأعمال الفنّية لبعض فناني هذا الوطن ثقافةً جديدة، لكنّها تحافظ على الشعلة التي لا تزال تقاوم الموت والعبث والحروب والفساد، وتمنح حضورًا حسّيًا لفعل الرسم المهدّد بالذوبان في جنون العصر. فنحن نقاوم بالفنّ زمن الاندثار والجهل والبشاعة. وعلى الرغم من المستويات المتفاوتة في أعمال الفنانين والمعارض، إلا أنّ حضور هذه المعارض يحافظ على وجودنا ضد الزوال.
بيع الأعمال لفنان ما – كما قلنا سابقًا – لا يعني بالضرورة أهميّته وفرادته؛ فالعملية استثمارية تجارية تخضع لأمور كثيرة كما ذكرنا. لكنّ الإيجابي في العملية هو استفادة الفنانين المحظوظين من عملية البيع لمواصلة عطائهم، حتى لو كان بعضهم دخيلًا على الفنّ والتخصّص، وينتفع على حساب آخرين. لكنّ هذا العطاء يبقى مقيدًا وخاضعًا لعدم الابتكار والخلق! إذ يخاف الفنان من تغيير أسلوبه ورؤيته كي لا يؤثر ذلك على عملية البيع والربح! كلامٌ قاسٍ، أعرف هذا، لكن لا بدّ من قول الحقيقة ووصف الواقع الذي لا يبني وطنًا جميلًا، ولا يؤسّس لمستقبل واعدٍ زاهر…
اشتروا الفنّ، وشجّعوا الفنانين؛ فـ “الفنّ يحرّك التاريخ…” حسب قول هيغل، و”كلما رسمنا جيّدًا، حصلنا على وطن جديد” كما قال فان غوغ… وأضيف قائلًا: إن وطننا بحاجة ملحّة إلى الفنّ الأصيل الجيّد والجاد، لنقاوم البشاعة والموت البطيء… فالفنّ هو رأسمال الأوطان والتاريخ والأجيال.
* المصدر: مجلة البعد الخامس
 الخيام | khiyam.com
الخيام | khiyam.com 


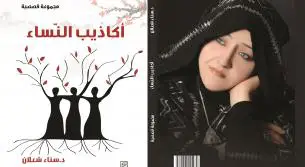








تعليقات: