
في الفاصل الأخضر بين المنصوريّة والحازميّة يمتدّ وادٍ يهبط من تلال المتن إلى نهر بيروت. بين العرائش والصخور تنبض بقايا قناطر حجريّة شامخة، تشهد لمسار قناة جرٍّ رومانيّة غذّت «بيريتوس» بالماء زمن ازدهارها المدنيّ. تتدلّى الأقواس فوق الهوّة مثل سبابة مهندسٍ قديم يرسم خطّ الحياة من عينٍ بعيدة نحو قلب المدينة. خلف هذا المشهد تقف حكاية تخطيط مائيّ متقن، ومخيّلة تقنيّة صاغت عمران بيروت الأولى حول الحمّامات والصهاريج والشبكات الدقيقة.
الديشونيّة ونهر بيروت
قامت روما على مبدأ إدخال الطبيعة في خدمة المدينة عبر هندسة دقيقة للمنسوب والجريان. في بيروت اختار المهندسون منبعًا على مجرى نهر بيروت عند نبع الديشونيّة في أعالي المتن الشرقيّ، ثمّ رسموا قناة تتبع السفح نزولًا نحو المدينة. المسار كان ثمرة دراسة دقيقة لتضاريس الأرض، حيث وُظّف الانحدار الطبيعيّ لخدمة الجريان، في تناغمٍ بين العلم والبصيرة المعماريّة.
أقواس فوق الوادي
عند نقطة العبور الأشدّ وعورة، يتكشّف مزيج من العلم والجمال في هندسة القناطر. فقد ارتفعت صفوف من الأقواس الحجريّة على أكثر من مستوى لتتجاوز عمق الوادي الذي يبلغ نحو 44 مترًا، وتحافظ في الوقت نفسه على الميلان الهيدروليكيّ الذي يسمح بانحدار الماء المستمرّ. كانت هذه الأقواس جزءًا من بنية مركّبة تحوّل الثقل إلى توازن، والميل إلى حركة. في الأعلى تمرّ القناة المغطّاة بحجارةٍ مصقولة ومونة كلسيّة تمنع التسرّب، لتتابع طريقها فوق المنحدرات كخيطٍ من الماء المرسوم بدقّة هندسيّة مذهلة.
من هناك، عبرت القناة نهر بيروت عند قناطر زبيدة مثل جسرٍ معلّق بين زمنين، ثمّ تابعت مسارها عند سفح الحازميّة متتبّعةً المنسوب الطبيعيّ للأرض. كانت تتحرّك بانحدارٍ خفيف بالكاد يُرى، تمرّ بين الحقول وبساتين الزيتون، وصولًا إلى تخوم مار مخايل وفرن الشبّاك، حيث تقترب من قلب المدينة. في هذا المسار الطويل، لم تكن القناة مجرّد ممرّ مائيّ، بل خطّ عمرانيّ يرسم الحياة حوله؛ فالمزارعون استقرّوا بقربه، والحرفيّون أقاموا ورشهم عند أطرافه، والطرق التي تربط الساحل بالمرتفعات كانت تتقاطع معه في نقاطٍ محدّدة لمراقبة تدفّقه وضمان صيانته.
نحو الصهاريج الرومانيّة
وعندما تبلغ السفح الغربيّ، تتّجه نحو المنطقة التي تُعرف اليوم بـ ساحة رياض الصلح، حيث كانت الصهاريج الرومانيّة الكبرى في بيريتوس تنتظرها. هناك يحفظ الماء في خزّاناتٍ مقبّبة من الحجر الكلسيّ والجير، تعلوها فتحات تهوية تحفظ برودة السائل ونقاءه. ومن هذه الصهاريج يبدأ الفصل الأخير من الرحلة: توزيع الماء نحو الحمّامات العامّة، والبيوت الكبرى، والميادين، عبر أنابيبٍ من الفخّار والرصاص. كانت الشبكة تعمل وفق نظامٍ صارمٍ من الصيانة والتوقيت، فالماء يجري بانتظام ويُدار بعناية كأنّ المدينة جسدٌ يعي نبضه.
بهذا الترتيب يتجلّى منطق الشبكة المائيّة بكاملها: جمعٌ عند المنبع، نقلٌ بمنسوبٍ محسوب، خزنٌ عند السفح، ثمّ تغذيةٌ للحياة اليوميّة في بيروت القديمة. هندسةٌ تعرف أنّ المدينة تعيش من نبض الماء الذي يجري في عروقها الحجريّة. قناطر زبيدة ليست جسورًا للماء وحسب، بل رمز للانسجام بين الطبيعة والعقل، بين جريان النهر وانحناءة القوس، بين الارتفاع الذي يُبقي الماء حيًّا والعمق الذي يصونه.
فلسفة القنطرة في العمارة والهندسة
القنطرة فكرٌ هندسيّ وفلسفة توازن بين الثقل والإنسياب. في أصلها، تعبيرٌ عن مصالحة الإنسان مع الجاذبيّة، إذ يحوّلها من قيد إلى ركيزة. القوس يوزّع الوزن بذكاء، يجعل الصخر يطير دون أن يفقد صلابته. إنّها فكرة الجسر الذي يتآلف مع الطبيعة، يوحّد بين الضفّتين دون أن يطمس الفراغ بينهما.
في الهندسة الرومانيّة، كانت القنطرة رمز الانتصار على الزمن عبر انحناءتها التي تعيد الحمل إلى الأرض برفق، مثل انحناءة جسدٍ يعرف حدوده. أمّا في المعمار الشرقيّ، فأضحت القنطرة استعارة للجسر بين الأرض والسماء، بين المادّة والروح. في قناطر زبيدة يتجلّى هذا المعنى بأبهى أشكاله: هندسة تُجري الماء، لكنّها في الوقت نفسه تُجري الفكرة، وتحوّل المجرى إلى قصيدة من الحجر.
قياسات المكان ودلالتها
يقارب الطول 240 مترًا، والارتفاع نحو 44 مترًا فوق مجرى النهر، وهو رقم استثنائيّ في مقاييس القناطر الرومانيّة في المشرق. تتعاقب الأقواس كتنويع موسيقيٍّ على لحنٍ واحد، تحوّل الوادي من عائقٍ إلى ممرّ مائيّ متوازن، في تفاعلٍ مع قوانين الانحدار والجاذبيّة. كلّ قوسٍ يشكّل وحدة إنشائيّة قائمة على مبدأ توزيع القوى المحوريّة والجانبيّة، حيث ينتقل الحمل من تاج القوس إلى الكتف ثمّ إلى الدعامة، فتتوزّع الضغوط على شكل مثلّثات توازنيّة تمنح البناء ثباته. هذه التقنيّة، المعروفة في العمارة الرومانيّة باسم opus arcuatum، سمحت ببناء منشآت مائيّة شاهقة دون استخدام المعدن أو الخشب كدعّامات.
يقارب طول قناطر زبيدة 240 مترًا، والارتفاع نحو 44 مترًا فوق مجرى النهر، وهو رقم استثنائيّ في مقاييس القناطر الرومانيّة في المشرق
كانت مادّة البناء حجرًا كلسيًّا محلّيًّا مقطوعًا بعناية، يُرصّف في صفوف متناوبة بربطٍ أفقيّ عموديّ لضمان التماسك. المونة الجيريّة الممزوجة بالرمل البركاني (البوزولان) تعمل كعازلٍ للماء، وتمنح الحجارة قدرة على ”التنفّس“ وتحمّل التمدّد الحراريّ والرطوبة. في أعالي القناطر يمتدّ المجرى المائيّ بعرض يقارب المتر وعمق نصف متر، مغلّفٌ بطبقة كلسيّة ناعمة تمنع التسرّب وتخفّف الاحتكاك الداخليّ للماء، ما يسمح له بالإنسياب وفق ميلٍ هيدروليكيٍّ لا يتجاوز الـ 0.15 في المئة، أيّ ما يعادل خمسة عشر سنتيمترًا في كلّ مئة متر من المسافة، وهي دقّة مذهلة في القياس بالعين والميزان المائيّ آنذاك.
لم تكن الأقواس هنا تكرارًا زخرفيًّا، بل سلسلة حسابات دقيقة لتوجيه الضغط والضوء معًا. فبين كلّ قوسٍ وآخر تتولّد فراغات تسمح بمرور الهواء وتخفيف الرياح الجانبيّة، وتخلق في الوقت ذاته إيقاعًا بصريًّا يربط بين المجرى والسماء. في كلّ حجرٍ منحوتٍ زاوية وغاية، وفي كلّ قوسٍ حسابٌ للظلّ والضوء والميلان، حتّى تبدو القناطر وكأنّها تكتب معادلةً هندسيّة بلغتها الخاصّة: وزنٌ يعلو، وماءٌ يجري، وحجرٌ يطيع العقل دون أن يفقد طبيعته.
أسماء المكان وسيرتها
يحمل الاسم «قناطر زبيدة» طبقاتٍ من الذاكرة الشعبيّة؛ بعضهم ينسبها إلى زبيدة زوجة هارون الرشيد، وآخرون إلى زنّوبيا ملكة تدمر. هذا التنوّع يعكس رغبة الناس في ربط المكان بشخصيّاتٍ أسطوريّةٍ تحرس الماء وتخلّد الأثر. إلّا أنّ الدراسات الأثريّة تؤكّد أنّ هذه القناطر رومانيّة الأصل، شُيّدت في القرن الثالث الميلاديّ خلال عهد الإمبراطور أورليان، ضمن مشروع واسع لتزويد مدينة بيريتوس بالمياه العذبة.
تتجلّى القناطر في لحظة التحوّل التي انتقلت فيها بيروت من مستوطنة ساحلية إلى مدينة رومانيّة كبرى. الحاجة للماء أنجبت نظامًا متكاملًا من الجرّ والقناطر والصهاريج.
قناطر زبيدة درسٌ مفتوح في عبقريّة العلاقة بين الشكل والوظيفة، ومختبرٌ لفهم كيف يمكن أن يبني الإنسان مدينته من خدمةٍ قبل الواجهة، وكيف يمكن لحجارةٍ صامتة أن تروي قصّة الماء والعقل والحاجة والجمال.

قناطر زبيدة

 الخيام | khiyam.com
الخيام | khiyam.com 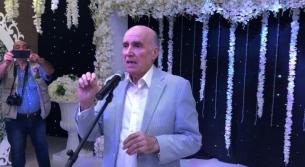







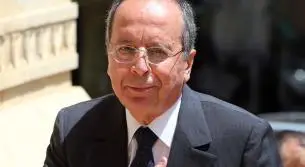



تعليقات: